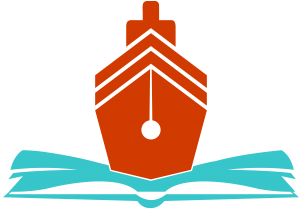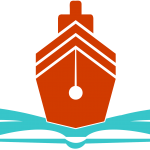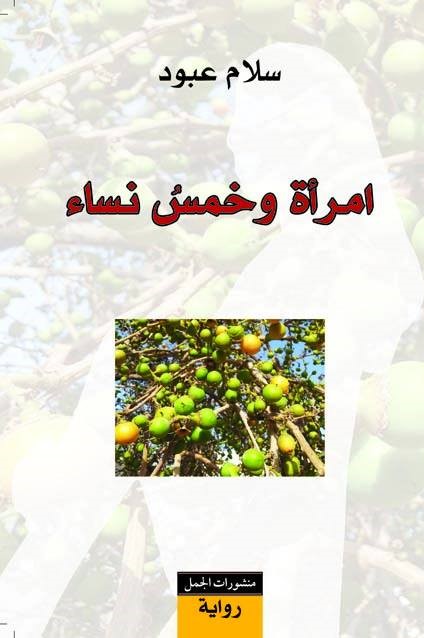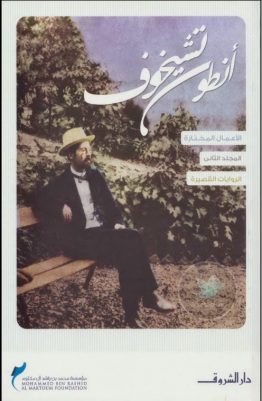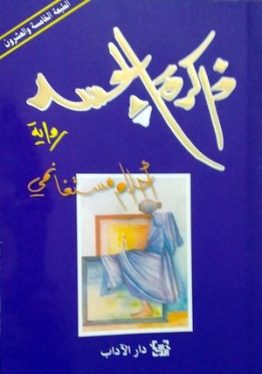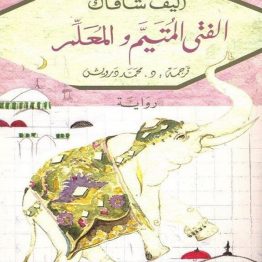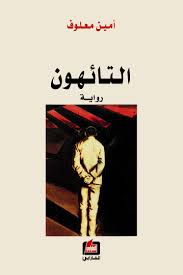سلة المشتريات
امرأة وخمس نساء
€15.00
غير متوفر في المخزون
الوصف
الكلمتان الأوليان تشيان بما هو مذكر، والأخريان تحسب للمؤنث. هل ما حدث وما يحدث يتلخص في الصراع بين الرجل والمرأة؟ ولكن علينا أن نحزرَ قبل كل شيء الفارق بين امرأة كمفرد، ونساءٍ بالجمع، وطالما صفّها الكاتب بهذا التسلسل؛ «امرأة وخمس نساء» فقد أكسب ولاشك الأولى فرادة دون الباقيات، فهنّ الجمع الذي تربطه افتراضا صفات مشتركة تخلع عنه تميّزه. ومَنْ هي تلك التي تتفرّد من بين هؤلاء الست. «امرأة وخمس نساء» هو عنوان الرواية الصادرة حديثا للروائي العراقي سلام عبود؛ العنوان ولاشك لحاله أحجية. تنطلق الرواية من لحظة تاريخية في عدن لأخطر تجربة سياسية عربية في تاريخنا المعاصر، نتتبّع تفاصيلها من خلال أربع عوائل يمنية تقيم في حي سكني راقٍ لمسؤولي الدولة والحزب الكبار، بالإضافة إلى الدبلوماسيين من العرب والأجانب. تجتمع تلك العوائل مضطرة تحت سقف واحد لبيتٍ دارتْ من حوله المعركة بين الأطراف المتنازعة على السلطة في يناير/كانون الثاني 1986. الجميع في مرمى النيران، وما سيتكشّف يتعدى مَن البادئ في إطلاق النار، مَنْ الذي سيفوز في النهاية، مَنْ يوالي مَنْ، وذلك عبر سَردٍ دقيق امتدّ على مساحة 479 صفحة من الرواية. لماذا اليمن؟ لا مبرر للسؤال بعد الانتهاء من قراءة الرواية وكما ذكر، فالسرد يتناول هذا الحدث المفصلي في تاريخ اليمن الوطني والعربي القومي والأممي، الذي تزامن مع مآل حركة اليسار العربي عموما، فالرواية تكشف لنا عن سلسلة من الدوافع التي أدت إلى اندلاع الثورة بتفاصيلها والتي مازال جزء كبير منها مغيبا أو خفيا. مأساة نتحسسها عن قرب، تعكس معايشة قريبة عبر النص، ومن خلال تعدد الرؤى من قبل عيون النسوة المتحركة في ذلك الحيز الضيق الذي حُشِرن فيه، حيث يتوضح المسك بأطراف الصراع والجدل بشأنه. مرّت بعض شعوب المنطقة العربية بتجربة تكاد تكون مشابهة في جانب آخر منها، من ناحية الحديث عن حزب شمولي تعلوه أجواء الفساد والشللية والتواطؤات والخيانات والقتل، مناصب حكومية وحزبية ومنافع وصفقات، الفارق هنا هو أهداف الحزب الحاكم ذاته وولاءاته؛ اشتراكيا، شيوعيا، ماركسيا، لترتسمَ صورةٌ ما من خلال البعثات الدراسية. سلطة التمثيل الدبلوماسي في الدول الاشتراكية، الكافيار والنبيذ الكوبي، وأيضا العراقيون الفارون من حملة مطاردة البعثيين لهم وزجّهم للبعض في الاشتباكات التي حصلتْ (وللمفارقة اقترنوا في ذاكرة بعض النسوة اليمنيات بـ»خمّاراتهم»). وقد لا يكون، حين نحصي الخسائر، للاختلاف بين نظام قومي عربي واشتراكي علمي سببا يُذكر، فطبيعة المجتمعات هذه لم تستوعب تلك التجارب (تجربة بناء مجتمع اشتراكي) وتعيش تناقضا مفضوحا، وإن بدتْ ملامحُ التغيير في جزء منها ظاهريا في التوجه السياسي، وبعض القوانين للدولة. وقد تعود المعركة الراهنة برمتها إلى «ختان وقات»، كما عقّبت بعفوية وفطرة إحدى البطلات. بين أحداث خارجية تصف الحرب الأهلية وتطوراتها ودور الرجل فيها، وبين تفاصيل يومية من داخل البيت وعلى لسان حارساته، نتلمس المجتمع العربي بكل «أشجانه». المرأة (المثقفة) هنا تتبوأ منصبا وظيفيا متقدما، ومنصبا سياسيا في الدولة والحزب، تؤمن بالمساواة وتدعو إلى حرق «الشيذر» في ظل قانون أحوال شخصية يحرّم الزواج من اثنين. إلى جانب سلسلة من الأعراف العشائرية والقبلية التي فُطرَت عليها، فنسبة الأناث المختونات لازالت حتى اللحظة عالية جدا، وهي من الظواهر الخطيرة التي تصعب مكافحتها. حقيقة (تصعب مناقشتها مع من نعرفهن او الدفاع عنها من قبلهن)، تجسدت في الرواية بالتعامل معها كـ»تابو» بين النساء المثقفات أو المتحررات، بخلاف الجنبية والقات والمقيل. وقد يكون ذلك هو في صلب موضوع الرواية التي حاول من خلالها الكاتب (ببراءة وانسيابية على السطح، وبأسلوب التحري والنبش في العمق) سبر غوره؛ مَنْ هي المرأة المتحررة؟ الجنس على لسان تلك النسوة المعلّقات الضائعات المنتظرات لمصيرهن كان مفتاح الروي لكل ما دار ويدور، يتساءلن عن حقيقة دورهن، عن علاقاتهن بأزواجهن، عن حقيقة عواطفهن وما يشعرن به في دواخلهن؛ كوسيما المجرية، المرأة الأجنبية التي تنتمي إلى ثقافة أوروبية آخذة بالابتعاد عن صراع الأجساد ورموزها، وهي تملك جسدا لا تصنع أحاسيسه إرادة غيرها كما تقول؛ «الموضوع لدي لا يتعلق بحرية الممارسة، بل بحرية الإحساس بالممارسة». أَمْ صباح الجميلة المتمردة على ذكور البيت، سيدة الأعمال المستقلة اقتصاديا التي تطمع بالسلطة والمال، تؤجل دورها الأمومي لحين، وتزيح ما يقف في طريقها ويحول دون استغلالها لقانون الاستثمار وتوسعة القطاع الخاص بكل الأساليب التي قد تصل بسبب الجشع إلى التفكير بالقتل. أم أُنس التي عاشت حياة الطالبات الجامعيات في الخارج وتقترن بمسؤول وإن تعارض موقفه السياسي مع موقف العائلة دون أن تدرك ما كان من حقيقة خيارها. أَم شفيقة البنت الشعبية التي يشكّك في شرف أصلها، ما من شأنه لربما تحريرها من كل القيود المتعارف عليها. اليمن كمشروع كلي، اليمن على لسانهن، بمختلف بيئاتهن وتحدّراتهن، اليمن بتاريخ تقلباتها السياسية، بتاريخ العنف الذي لم يكن مشروع الكاتب الأول في تصديه له، في تشريحه ثقافيا وسلوكيا، أدبيا ولفظيا. استعراض واسع للعلاقات السياسية الداخلية، والخارجية والدبلوماسية للبلد حينها، للبعد الجمالي للبقعة، لتناول اليوم اليمني بتفاصيله من ناحية وجبات الطعام، العلاقات الأسرية، الأمكنة، اللغة المتداولة والأسماء والأمثال المتداولة وحتى التنويمة، كل ذلك يشير إلى نبعٍ عاطفي لدى عبود يخصّ البلد، إلى جانب إلمامه الفكري بطبقاته وموروثه الشعبي. بناء فني فريد يحاصر فيه سلام عبود أبطاله في مساحة تضيق وتضيق ولا يكلّ حتى النهاية من استنطاقهم من أجل الوقوف على حقيقة فشل التجربة، ولتتكشف لنا شيئا فشيئا الأوجه الأخرى للإنسان في هذا المجتمع بغرائزه وغاياته وطبائعه. من خلال سيرة عبود الأدبية نجد سلسلة من الكتب التي تضمنت بحوثا ودراسات في التاريخ اليمني وتاريخ الأدب اليمني بحكم إقامته على مدى سنوات هناك، وقد توجتها هذه الرحلة الشاقة وربما الأهم بما يخص هذا الحدث الذي حاول أن يتوخى الأمانة في سرد تفاصيلها، عبر فترة زمنية تجاوزت في كتابتها العشرين عاما.
المصدر: القدس العربي
معلومات إضافية
| المؤلف | |
|---|---|
| الناشر | |
| سنة النشر | |
| عدد الصفحات | 480 |
| الرقم الدولي (ISBN13) | 978-9933-352-30-1 |